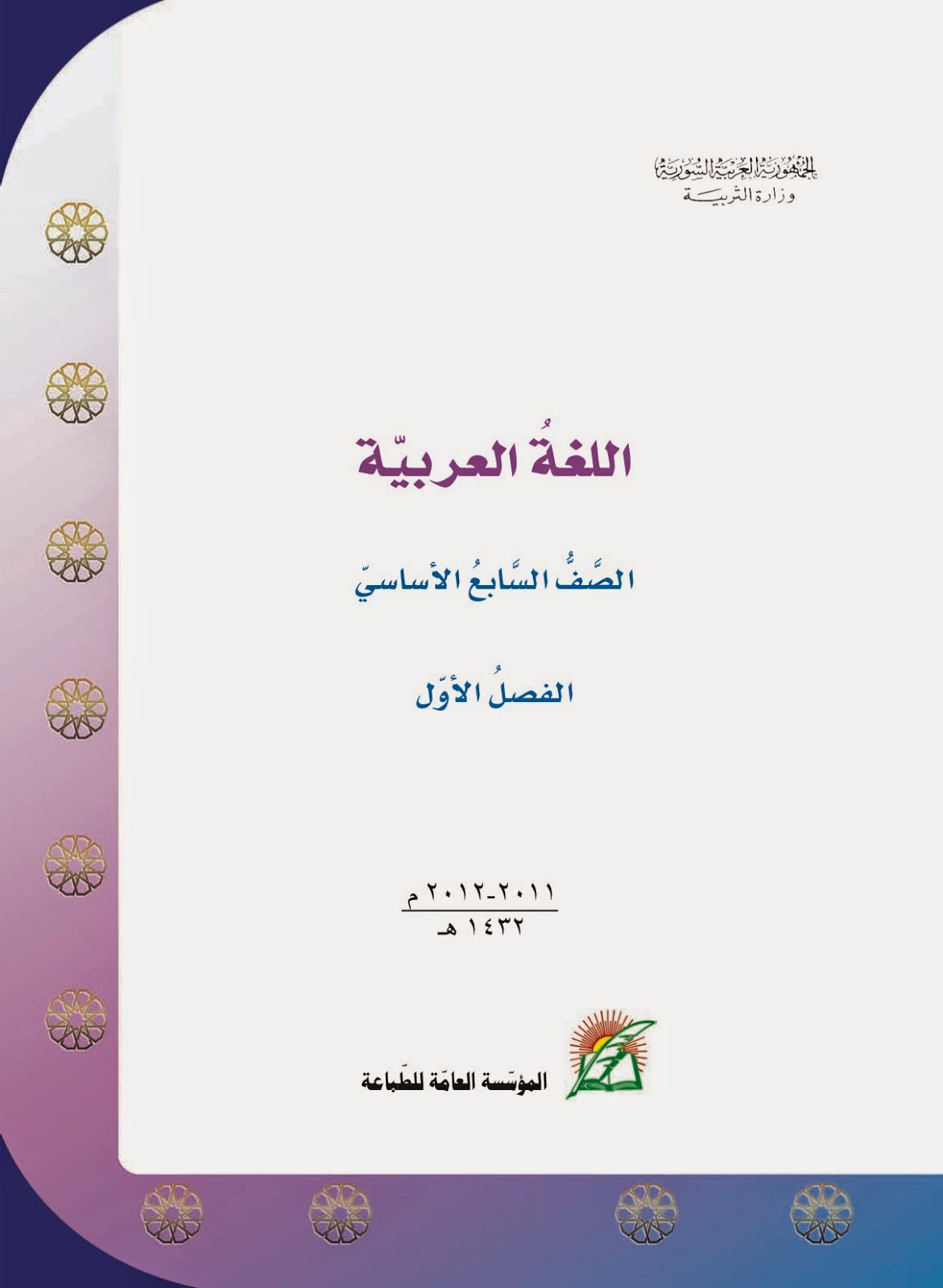هنالك أربعة مصطلحات لا مناص من العودة إليها بهذا السياق: الشعب، الرعية، السياسة والدولة.
سلمان مصالحة ||
اللغة العربية تكشف مآسينا الراهنة
الأعوام الأخيرة وما حملته معها من عواصف ضربت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه لا تزال تشغل بال البشر في هذه البقعة من الأرض. غير أنّ المتتبع لما يُكتب ويُشاع من جانب النخب العربية حول هذه المآسي يجد نفسه في حيرة من أمره. وعلى هذه الخلفية لا يسعنا سوى القول، إنّ هذه الحيرة مردّها إلى التخبّط الذي يُنحي باللائمة على كلّ ما يخطر ببال العربي، مُبقيًا نفسه استثناء من هذه اللائمة. فمرّة يكون المُسبب للمآسي العربية هو أميركا، ومرّة تكون روسيا هي السبب. مرّة تكون تركيا ومرّة إيران والأمر يتعلّق بخلفيّة الردّاح الطائفية والسياسية. وكلّ هذا ناهيك عن إجماع الجميع بكلّ خلفيّاتهم على المؤامرة الصهيونية، أو الحضور الدائم لإسرائيل في القاموس العروبي بوصفها أسّ البلاء لكلّ ما هو حاصل في البيت العربي.
غير أنّنا، إذا توخّينا الصدق مع أنفسنا، نجد لزامًا علينا أن نعود إلى مدلولات لغتنا العربية لننظر فيما حفظته لنا هذه اللغة من مدارك قديمة لا زالت تفعل فينا أفعالها. فاللغة هي حافظة التصوّرات والمفاهيم المتجذّرة في أذهان أصحابها. وفقط بالعودة إلى المفاتيح اللغوية يمكننا تلمّس الطريق المفضية إلى فهم عميق لأحوالنا الراهنة. إذ لا يمكن فهم كلّ هذا التفتّت والتشرذم العربي إلاّ من خلال العودة إلى بعض المصطلحات المنتمية إلى عالم الاجتماع والسياسة.
هنالك أربعة مصطلحات لا مناص من العودة إليها بهذا السياق: الشعب، الرعية، السياسة والدولة.
إنّ الحديث عن سريان مفعول المصطلح «شعب» على أحوال الكيانات السياسية العربية هو حديث لا يستند إلى أيّ أساس متين. فلو عدنا إلى مدلولات هذا المصطلح كما يعرضها علينا كتاب العرب الأوّل، القرآن الكريم، وكما فسّره لنا السّلف بمفاهيمهم الأقرب إلى المدارك المتجذّرة في هذه البقعة، سنجد أنّ الـ«شعب» لا يعني بأيّ حال ما تعرضه المفاهيم المعاصرة القادمة إلينا من حضارات أخرى. لقد ميّز القرآن في سورة الحجرات بين الـ«شعوب» والـ«قبائل» التي يفترض أنّّها ستتعارف. فها هو مقاتل بن سليمان وهو من أقدّم المفسّرين ينيرنا بأنّ الشعوب تعني: «رؤوس القبائل: ربيعة ومضر وبنو تميم والأزد»، بينما القبائل تعني: «الأفخاذ: بنو سعد، وبنو عامر، وبنو قيس، ونحوه». أمّا الزمخشري فيلخّص في الكشّاف هذا المفهوم بالقول: «الشّعب الطبقة الأولى من الطبقات الستّ التي عليها العرب، وهي: الشّعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة… فخزيمة شعبٌ، وكنانة قبيلة، وقُرَيش عمارة، وقُصَيّ بطن، وهاشم فخذ، والعبَّاس فصيلة». وهنالك من ذهب إلى القول، مثلاً كالفرّاء في ”الأحكام السلطانية“، بأنّ الشعوب تسري على العجم بينما القبائل هي ما يسري على العرب. وبكلمات القشيري: «الشعوب من لا يُعرف لهم أصل نسب كالهند والجبل والترك، والقبائل من العرب.»
وإذا انتقلنا إلى المصطلح الثاني وهو «الرعيّة» والـ«رعايا» وهو المصطلح الموازي للـ«مواطنين» في الخطاب المعاصر، فماذا نجد في دلالاته؟ لنذهب إلى لسان العرب فهو يفيدنا بالخبر اليقين. فالـ«رعايا»، كما يذكر ابن منظور هي: «الماشية المرعيّة». أي إنّ الـ«رعيّة» هي قطيع البهائم التي يتولّى الراعي رعايتها. ويضيف ابن منظور: «رعى الأمير رعيّته رعاية، ورعيت الإبل أرعاها رعيًا… ورعاية. وكلّ من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيّته». وهكذا فإنّ الأمير، أو الحاكم العربي بعامّة، هو بمثابة الراعي الذي يتولّى أمر رعيّته، أي قطعان البهائم. وليست تلك البهائم الراعية سوى المحكومين من بني البشر الذين يُصطلح تسميتهم «مواطنين» في هذا العصر.
ولمّا كانت طباع البهائم من هذه الرعايا مختلفة، والبعض منها شموص فهي بحاجة إلى عمليّة ترويض لتمتثل لأوامر الراعي. هكذا نصل إلى إلى الحديث عن المصطلح «سياسة». فالسياسة العربية هي في جوهرها عملية ترويض لقطعان الرعيّة. بهذا السياق نعيد إلى الأذهان حديثًا مرفوعًا إلى الخليفة عمر بن الخطّاب، يورده لنا الطبري في تاريخه. وهو حديث يصف فيه عمر نفسه بالـ«سياسة»، فيقول: «فوالله إنّي… أنهز اللفوت وأزجر العروض… وأضم العنود وألحق القطوف وأكثر الزجر وأقل الضرب وأشهر العصا…». وحينما روي هذا الحديث في حضرة معاوية بن أبي سفيان قال: «كان والله عالمًا برعيّتهم».
أمّا الدولة في التصوّر العربي فليست هي هذا الكيان الذي يدور الحديث عنه في هذا العصر. ولكي تتضّح لنا الصورة نعود إلى الأصول العربية، كما حفظها لنا السلف. فها هو حاشد ذو مرع عندما تملك على حمير، كما يذكر نشوان الحميري في مؤلفه ”ملوك حمير وأقيال اليمن“ فقد قام وجمع حمير وكهلان وخطب فيهم قائلاً: «أيّها الناس، إنّ لكلّ قوم دولة، ولكلّ دولة مدّة، كما لكلّ حاملة تمام، ولكلّ مرضعة فطام». فالدولة هنا ليست مرتبطة سوى بالـ«قوم»، أي بالقبيلة. وتعزيزًا لهذا المفهوم نجده في خطبة ذو يقدم بعد أن استخلف ابنه على الملك: «واعلم أنّ نظام الدولة في اتفاق الأهواء على الملك واجتماع الكلمة معه». فالدولة هي التملّك القبلي واجتماع الآراء والأهواء على هذا التملّك. وهاكم تعزيزًا آخر لهذا المفهوم. ففي معرض الحديث عن بني نمير يذكر لنا ابن سعيد في نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب: «دخل بنو نمير، في الإسلام، إلى الجزيرة الفراتية، فكان لهم هنالك دولة، ثم خمدوا فليس لهم ذكر». أي إنّ الدولة هي كما يذكر ابن منظور في اللسان: «أن تُدال إحدى الفئتين على الأخرى. يُقال: كانت لنا عليهم الدولة». وبكلمات أخرى، هي سلطة فئة، أو قبيلة، أو طائفة على أخرى. ولهذا تذكر لنا المصادر هذا المصطلح مرتبطًا بفئة أو بشخص، فتعجّ المصادر بمصطلحات مثل: دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة عثمان، دولة الفاروق، دولة هشام، دولة مروان الحمار إلى آخره.
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أحوال العرب في هذا الأوان، نجد أنّ كلّ هذه المفاهيم لا زالت تسري على هذه الكيانات المسمّاة دولاً عربية. فها هو الكيان السوري ليس سوى استمرار لهذه المفاهيم التي لم يأكل عليها الدهر في هذا الأوان، فسورية هي «دولة الأسد أو نحرق البلد»، مثلما أنّ العراق كان «دولة صدّام»، وليبيا «دولة القذافي» أو هذه القبيلة أو تلك. وكذا هي الحال مع سائر الكيانات فهي دول سلالات لبني فلان وبني علان. بينما المواطنون هم قطعان من الرعيّة يجب ترويضهم، لكي لا تصبح لهم الدولة.
خلاصة القول، ما لم نفهم جذور لغة خطابنا العربي السياسي والثقافي والاجتماعي فلن نفلح في الخروج من المآزق العربية الراهنة. بدل ذلك سنواصل التخبّط في مستنقعاتنا الآسنة ناسبين كلّ أسباب مآسينا إلى الآخرين.
*
”الحياة“، 18 سبتمبر 2017




 سلمان مصالحة
سلمان مصالحة